ماذا لو لم يخترع الإنسان الأدوات التقنية التي ساعدته على مواجهة تحديات الحياة الطبيعية؟ من المؤكد أنه كان سيظل كائنا طبيعيا مثله مثل الكائنات الحية الأخرى. أن أهم ميزة للإنسان تكمن في قدرته على الاكتشاف والابتكار فالبرد القارصة دفعته إلى التفكير في البحث عن الدفىء فاكتشف النار والحر الشديد دفعه للتفكير والبحث عن ظل يقيه الشمس والمطر فاكتشف الأشجار والاحجار والكهوف والمغارات وفي سبيل قطع النهر وصيد السمك اكتشف الخشب وصنع الزوارق والسفن ومن أجل مواجهة الوحوش والضواري ومنافستها في الحصول على قوته في الغابات والبراري اخترع القوس والنشاب والسهم والرمح. وفي سبيل استصلاح الأرض وزراعتها ابتكر الفأس والمنجل وادوات الحرث والري والزراعة وهكذا كان الحال مع مشكلات الحياة الاخرى وسبل حلها وتجاوزها وعلى مدى ملايين السنين من الخبرات والتجارب في علاقة الإنسان بالأشياء صارت التكنولوجيا هي أهم عوامل التغيير والتقدم والتطور.
ومن لوح الخشب العائم تطورت السفن العملاقة ومن السهم الطائر تطورت الصواريخ الفتاكة ومن الحمام الزاجل تطورت وسائل الاتصالات والمعلومات ومن الكهف والمغارة نشأت ناطحات السحاب والحصون العالية ومن النار تطورت الكهرباء ومصادر الطاقة المعاصرة ولا شيء في تاريخ تطور الحضارة البشرية جاء من خارج علاقة الإنسان بالأشياء كان التاريخ قبل الثورة الصناعية يكرر ذاته بانماط متشابهه من الحركة الدائرية التقليدية التي تدور حول فلك القوى والشروط الطبيعة للحياة الأرضية بين الأرض والسماء بما تجود به من عناصر العيش وادواتها التقليدية الأولية ومنها ( الأرض والمطر والزرع والثمر والريح والانهار والبحار والمحطات والحيونات) وهكذا ظلت علاقة الإنسان بالإنسان شبه ثابتة عبر التاريخ بينما تغيرت علاقة الإنسان بالأشياء.
إذ يوجد نمطان للعلاقات: علاقة الإنسان بالإنسان وعلاقة الانسان بالأشياء ، الاولى ثابتة ومستقرة ولم تتغير في جوهرها منذ هابيل وقابيل وبنية القرابة الاولى، اذا ما زال الناس كما كانوا في أولهم يحبون ويكرهون ويتزوجون ويتقاتلون اي بكلمة يمارسون ذات السلوك الذي كان يمارسه الانسان الاول حواء وآدم واولادهما يتزاوجون وينجبون ويسعون في الارض ويفسدون ويتخاصمون ويسفكون دماء بعضهم بعضا في سبيل الحصول على الارزاق والخيرات والمصالح والحاجات وعلى مدى تاريخهم الطويل المفعم بالتنازاع والتقالب والصراع ظل التاريخ البشري محكوم بالقانون الطبيعي مقاومة الفناء والحفاظ على البقاء ! يدور حول محور القوة والحرب والربح والاحتكار وهكذا ظلت السياسة على مر الازمان هي الزمن الذي بمعنى أن الوجود السياسي للناس في المجتمع هو وجود شبه ثابت في بنية المجتمع الأساسية، مثله مثل بنية القرابة، وكل لحظة من لحظات التاريخ السياسي للمجتمعات تمثل الدرجة الصفر؛ وكل جيل يمسك بالخيط من أوله، ويردد في الوقت ذاته أنه يبتدع هيستيريات تحقيق الذات، والهلوسات الجماعية، والفصامات الطائفية، والهذيانات الدفاعية، والأخرى التفسيرية… وكما أن المراهق يتعلم المضاجعة دون أن يعلِّمه إياها أحد، ولكن دون أن يمارسها افضل مما مارسها جدوده، فإن كل حقبة اجتماعية تعاود اختراع السياسة، وكأنها لم تكن قط، هي هي سياسة كل زمن، الإشكالية بصورة جوهرية.
ويرى دوبريه أن هذه القرابة المزدوجة بين السلطان السياسي والميثولوجيا والشبق الجنسي نابعة بالتحديد من أن زمن الخرافة، وزمن غريزة الحب شريكان في البنية ذاتها، بنية التكرار. وهكذا نفهم الصلة الدائمة بين السياسة والدين والمجتمع بوصفها صلة راسخة الجذور في الكينونة الأولى للكائن الاجتماعي الديني السياسي بالطبع والتطبع ! وهكذا يمكن القول ان علاقة الإنسان بالإنسان ظلت راسخة النسيج ثابتة النسق وكل ما طرى عليها طوال ملايين السنيين لا يعدو بان يكون اكثر من ديكور اسمه الحضارة والتحضر تم اكتسابه اكتسابا بقوة السلطة والتربية والقانون وحينما تنهار السلطة والقانون في مكان من مجتمعات الإنسان يعود الناس الى سجيتهم الحيوانية الطبيعية الانانية الفطرية في حالة حرب الجميع ضدالجميع ! بينما علاقة الانسان بالأشياء شهدت وتشهد ثورات جذرية من التغير والتطور والتبدل والتنوع والارتقاء على على مختلف الأنحاء والمستويات الأفقية العمودية ، وبفضل تغيرها وتطورها تغيرت بيئة حياة الانسان على هذه الارض ، غير ان تغير هذه البئية لم يغير من النمط الأصلي للعلاقات الانسانية.
التكنولوجيا هي التي غيرت العالم الإنساني وإعادة تشكيل ملامحه إلى الحد الذي بات يصعب التعرف على بداياته. إذ شهد القرن الماضي النقلة الحاسمة في الثورة التكنولوجيا التجريبية المرتبطة بالتقاليد الاختباري الاستقرائي، وهي النقلة التي فتحت آفاقاً جديدة للعلم بحيث لم تتحقق أبداً منذ آدم وحواء تغييرات جذرية بهذه السعة في وقت قصير , هذا الحضور الطاغ للعلم وتأثيراته المضطردة في الحضارة المعاصرة هو الذي جعله ينبسط موضوعا كلياً لعدد واسع من أنساق المعرفة) : الأبستيمولوجيا ، وفلسفة العلم ، وتاريخ العلم ، وسوسيولوجيا العلم ، والانثربولوجيا الثقافية ، والنقد الثقافي والدراسات الثقافية, وعلم نفس العلم ، والعلم المقارن ، والعلم والميثودولوجيا ((علم المناهج, وأدب الخيال العلمي ، وفلسفة اللغة والهرمونطيقا ، والسبرناتيك وأخلاقيات العلم ..الخ). هكذا استقطب العلم اهتمام الفلاسفة والمفكرون, وأثار دهشتهم ، ودفعهم إلى إعادة التأمل والتفكير في سؤاله ومشكلاته الحيوية المثيرة للحيرة والقلق. (ما العلم؟ ما تاريخ العلم؟ وما منهجه؟ ما منطقه؟ وكيف يمكن فهم وتفسير بنيته وديناميته وصيرورته؟ وما علاقة العلوم الإنسانية بالعلوم الطبيعية وما الفرق بينها .. الخ ) من سلسلة الأسئلة المتناسلة التي أخد يضعها فلاسفة القرن العشرين محاولين استنطاق الظاهرة وفض بنياتها المتخفية وسبر أغوارها العميقة, في هذا السياق يمكن لنا النظر إلى الفيلسوف الأمريكي الشهير, توماس صامونيل كون الذي يعد بحق أبرز فلاسفة العلم في القرن العشرين بما أبدعه من خطاب فلسفي نقدي زاخر بالمفاهيم والأفكار البالغة الأهمية والقيمة والتأثير . والفيلسوف لا يأتي المعجزات فأقصى ما يستطيع القيام به هو أن يشيد صورة كلية عن العالم في العصر الذي يعيش فيه, فكل نظرة فلسفية محددة بعصر الفيلسوف وتصوراته وأسلوبه الفريد المتميز في النظر إلى مشكلات عصر ومعالجتها.
المؤكد أن الإعلام الجديد كان له الدور المحور في بلوغ هذا الانكماش، إذ أن التكنولوجيا الرقمية لم تِحدث فقط تحولاً في العالم، بل تمكنت من خلق عالمها المجازي أيضاً، فأقمار الإرسال التلفزيوني الصناعية اليوم مكنت الناس على طرفي الكوكب من التعرض بانتظام لطائفة واسعة من المحفزات الثقافية. فالمشاهدون الروس متعلقون بالتمثيليات التلفزيونية الأمريكية وقادة الشرق الأوسط، يعتبرون محطة الـ(سي إن إن) مصدراً رئيساً حتى للمعلومات والأفكار. فالموسيقى الأمريكية والأفلام الأمريكية والبرامج التلفزيونية أصبحت شديدة الهيمنة ورائجة جداً ومشاهدة جداً حتى إنها تتواجد في كل مكان على الأرض بالمعنى الحرفي للكلمة. وهي تؤثر فعلياً في أنماط وحياة وتطلعات كل الأمم، وهكذا لم تعمل العولمة على خلق عالم موحد، فهي ليست مرادفاً للتعبير (عالم واحد)، بل هي تتجه أكثر فأكثر إلى خلق نظام متشابك لعوالم متصلة، أي مرتبطة فيما بينها. وبهذا المعنى ندرك أهمية ثورة الإعلام الجديد في الاتصالات والمعلومات وتجليها الأبرز “الإنترنت” الذي يفضي على المدى البعيد إلى توسيع أفق الإعلام الجديد والمعرفة الإنسانية وتحريرها وتبادلها وتعميق الروابط الثقافية بين البشر، ويسعى إلى تكوين المجتمع العالمي، أي شبكة التواصل الاجتماعي المعاصر.
ولعل هذا التطور الحاسم هو ما دفع المفكر الأيطالي الجنسية لوتشيانو فلوريدي أستاذ فلسفة وأخلاقيات المعلومات في جامعة أكسفورد بالمملكة المتحدة ورئيس مجلة الفلسفة والتكنولوجيا في كتابه الثورة الرابعة؛ كيف يعيد الغلاف المعلوماتي تشكيل الواقع الإنساني إلى التساؤل من نحن؟ وماذا سنكون؟ وكيف نعيش؟
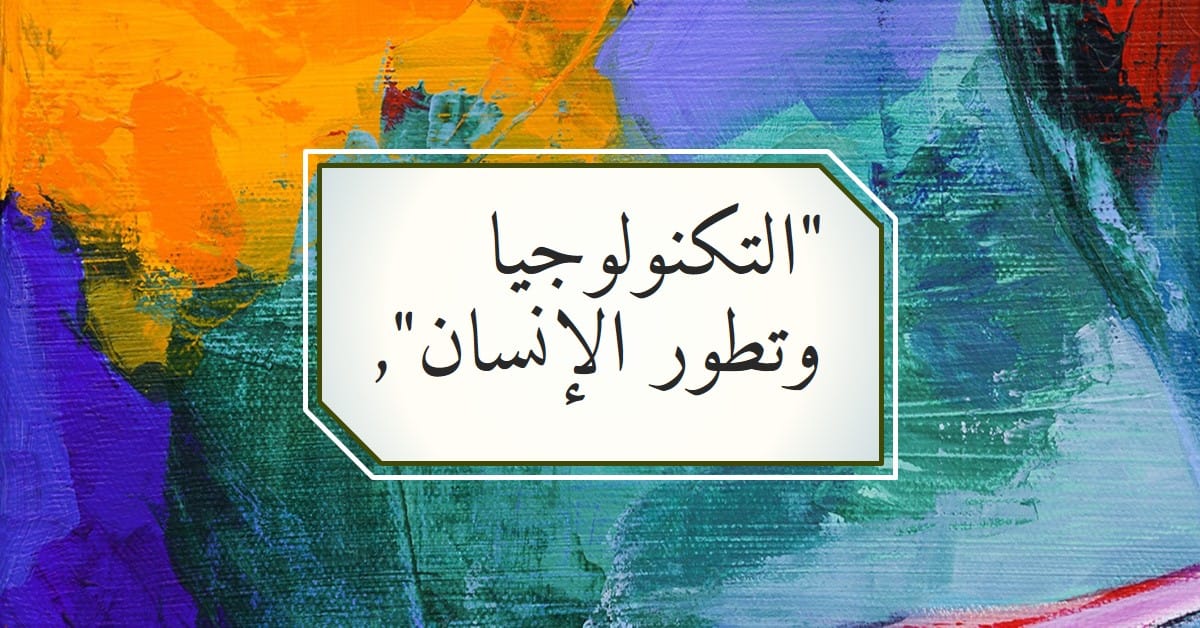
لا تعليقات